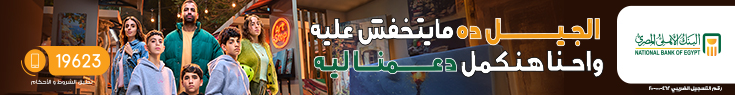“حمى SAT1” خطر عابر للحدود يُفاقم أوجاع الثروة الحيوانية
ويهدد أمن اللحوم والألبان في مصر
لم تكن الحمى القلاعية يومًا مجرد مرض بيطري عابر في الريف المصري، إنما كانت بمثابة امتحان متكرر لقدرة الدولة على حماية قوت الناس، إذ تنعكس كل إصابة في حظيرة نائية على سعر كيلو اللحوم في المدينة، وعلى كوب اللبن في كل بيتٍ بسيط، خلال الفترة الماضية عاد القلق ليتصدر المشهد مع تزايد الحديث عن عترة جديدة تسمى SAT1، توثقها التقارير المتخصصة في الإقليم وتلاحقها عيون الأطباء البيطريين، فيما تتردد على ألسنة المربين عبارة موجعة: “كل مرة بنلحق القديم، يطلع لنا جديد”.
في ذاكرة القطاع الحيواني المصري أنماط معروفة من الفيروس سادت سنوات طويلة: O وA وSAT2، على أساسها بُنيت تركيبة اللقاحات وجدولة الحملات القومية، وبينما اعتاد المجتمع الريفي التعامل مع موجات المرض بتكلفةٍ ومشقة لكن بقدر من الخبرة، جاءت العترة SAT1 لتفتح بابًا على مجهول علمي وعملي معًا: فجوة مناعية محتملة، ضغط بيطري مضاعف، وكلفة اقتصادية أعلى في وقتٍ يئن فيه المربون تحت ثقل تكاليف الأعلاف والدواء.
من “التحصين السيادي” إلى فوضى العترات: سردية عشرين عامًا من التبدل
حتى منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة كان المشهد أكثر بساطة، يروي خبير ثروة حيوانية، الدكتور عاطف شريف، أن مصر قبل 2006 لم تكن تعاني سوى من العترة O، وأن الهيئة العامة للخدمات البيطرية كانت تتولى التحصين “السيادي” مجانًا، فتسد المناعة أبواب العدوى وتبقي الخسائر في حدودٍ يمكن احتمالها.
لكن العام 2006 كان منعطفًا جديدًا؛ توسعت واردات الحيوانات من دول موبوءة، وضعفت قبضة الحجر البيطري في حالات بعينها، فتسربت عترات جديدة من الحمى القلاعية، ومعها أمراض أخرى كالجلد العقدي والحُمى المؤقتة، وانتقلت الحيوانات المصابة بين المحافظات قبل استكمال إجراءات الحجر، فدُفعت البلاد إلى موجات وبائية متتابعة.
توالت السنوات وتوالت معها “دروس قاسية” كما يصفها المربون، في كل مرة يتغير الفيروس، يتعين تغيير اللقاح، وتتسع الفجوة بين إمكانيات الاستجابة ومتطلبات السوق، وفيما تتعدد أصابع الاتهام بين فسادٍ في منافذ بعينها وتراخٍ في فترات سابقة، ظل الثابت الوحيد هو أن الثروة الحيوانية تدفع الفاتورة: رؤوس تُفقد، أوزانٌ لا تُستكمل، ألبان تتراجع، ومزارع صغيرة تغادر النشاط في صمت.
SAT1 على الأبواب: خطر وبائي بطعم اقتصادي
العترة SAT1 لا تزال في خانة “الخطر الإقليمي شديد القرب” بالنسبة لمصر، حتى لحظة كتابة هذا التحقيق لا توجد إعلانات رسمية عن انتشار واسع داخلي، لكن حركتها في دول الجوار، وخصائصها الجينية المختلفة عن الأنماط السائدة محليًّا، تجعل احتمالات الفجوة المناعية قائمة بقوة، معنى ذلك ببساطة أن اللقاحات الدارجة قد لا توفر حماية كافية، وأن أي تسلل غير منضبط للحيوانات المصابة أو الملامسة يمكن أن يحول موجةً محدودة إلى خسائر ممتدة.
في الحظائر، تبدو المعادلة بلا تجميل: الحيوان المصاب يتوقف عن الأكل، يتقرح الفم، يعرج، يهبط اللبن فجأة، ويحتاج إلى رعاية مكلفة، في مزارع التسمين يعادل اليوم الواحد من فقد الشهية أيامًا من إطالة الدورة الإنتاجية، وفي مزارع الألبان يتحول الانخفاض الحاد في الإنتاج إلى فجوة سيولة تضرب جدول سداد الأعلاف والعاملين.
خسائر المربين بالأرقام: كيف تبدو الفاتورة على الأرض؟
الأرقام هنا ليست ترفًا إحصائيًّا، بل لغة الواقع، في قطيعٍ ألبان مكون من مائة بقرة حلابة، تُظهر الخبرة الميدانية أن موجة حمى قلاعية غير مُسيطر عليها قد تُصيب نصف القطيع خلال أسبوعين، إذا هبط متوسط إنتاج البقرة المصابة بين ثلاث لترات وتسع لترات يوميًّا خلال فترة الأعراض وما بعدها المباشر، فذلك يعني فقدًا إجماليا قد يراوح بين 150 و450 لترًا يوميًّا للقطيع كله، ما يعادل آلاف اللترات في شهر واحد، في حسابات السيولة، هذا الفقد يكفي وحده لتعطيل دفع جزء معتبر من فاتورة الذرة أو الكُسب.
على مستوى النفوق، تميل القطعان البالغة إلى تحمل المرض، فتظل نسب النفوق المباشر محدودة في الظروف العادية، لكنها ترتفع بشكل واضح في العجول الصغيرة حيث قد يلامس النفوق في بعض البؤر النشطة واحدًا إلى اثنين من كل عشرة عجول إن غابت الرعاية والدعم الطبي في الوقت المناسبن هذه النسبة وحدها كفيلة بإراقة رأس مال المربي الصغير، لأن العجل ليس فقط حيوانًا في الحظيرة، بل مشروعًا مؤجلًا كان يُعول عليه.
في التسمين، تظهر الخسارة على هيئة وزنٍ مفقود لا يعود بسهولة، إذا كان معدل التحويل الغذائي قد تضرر لأسبوعين أو ثلاثة بسبب فقد الشهية والعرج وارتفاع الحرارة، فقد يخرج الحيوان من الدورة النهائية بعجز خمسة إلى سبعة في المائة من الوزن المستهدف مقارنة بدورةٍ سليمة، خذ قطيعًا من خمسين رأسًا، متوسط وزن البيع لكل منها 450 كيلوغرامًا، وافترض عجزًا بمقدار خمسةٍ في المائة بسبب موجة المرض؛ النتيجة فقد إجمالي بنحو ألف ومائة كيلوغرام لحم قائم، وهي فجوة تتضخم عندما يقارنها المربي بسعر السوق أو بقسط التمويل المستحق.
أما تكلفة العلاج والرعاية، فتتوزع بين مضاداتٍ حيوية للحالات الثانوية ومسكناتٍ ومطهراتٍ موضعية ومحاليل، إضافة إلى زيارات الطبيب البيطري، في المزارع الصغيرة يُقدر كثير من الأطباء التكلفة المباشرة للحالة الواحدة بمئات الجنيهات، وقد تتضاعف عند ظهور مضاعفات كالتهاب الضرع أو نفوق العجول، وإذا انتقلنا إلى تكلفة زمن الإنتاج الضائع، فإن الرقم يصبح أكبر وأفدح من مجرد أدوية وفواتير.
تأثير التراجع التراكمي: من الحظيرة إلى الميزان التجاري
تبدو الخسائر المتفرقة في كل قرية وكأنها قصص صغيرة، لكنها على المستوى القومي تتجمع لتصنع أثرًا كبيرًا في معادلة الأمن الغذائي، عندما يتراجع الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء، تكبر الفجوة بين العرض والطلب، فتتجه السوق إلى الاستيراد سواء في صورة لحوم مجمدة أو ماشية حية للذبح، هذه الفاتورة تُدفع بعملة صعبة، وتؤثر في توازنات اقتصادية حساسة، وعلى جانب الألبان، كل هبوطٍ في الإنتاج المحلي يُترجم سريعًا في تكاليف التصنيع وسعر العبوة للمستهلك النهائي.
وفي السنوات الأخيرة، تتحدث تقديرات مهنية متداولة في القطاع عن فقدٍ تراكمي في أعداد الماشية يتجاوز ثلث الطاقة المتاحة في بعض البيئات المحلية، مع فترات تذبذب متتالية في إنتاج اللحوم، التراجع ليس خطيًّا ولا منتظمًا، لكنه كفيل بإبقاء السوق في حالة توتر: موجة مرضية هنا تعني ضغط أسعارٍ هناك، ومزرعة تغلق في مركزٍ زراعي تعني فقد فرص عملٍ في مركزٍ آخر.
شهادة خبير: الذاكرة المؤلمة لـ2006 وحكاية “الحجر البطني”
ينقل خبير الثروة الحيوانية الذي عاش موجات 2006 شهادةً لا تخطئها العين: “كانت الهيئة تؤدي التحصين السيادي ضد العترة O بالمجان، والمشهد مستقر نسبيًّا، ما إن تراخت قبضة الحجر على واردات من دول موبوءة حتى توالت العترات والعلل.
تسريباتٌ متكررة، وأمراضٌ لم تكن مألوفة تظهر فجأة، وأسواقٌ مكتظة تنتقل بينها العدوى بسرعة، خلال خمس سنوات فقط خسرنا جزءًا فادحًا من ثروتنا الحيوانية، اليوم، ومع SAT1، الخطر أكبر لأن المناعة المعتادة لا تكفي،” يضيف الخبير تعبيرًا قاسيًا شاع في أوساط المربين منتصف العقد الماضي: “الحجر البطني” في إشارة ساخرة إلى متلاعبين دنسوا فكرة الحجر نفسها، مطالبًا بالضرب على أيدي الفساد أينما وجد، وبالعودة إلى منظومة تحصين عادلة تحمي صغار المربين بدل أن تُثقل كاهلهم برسومٍ متتابعة.
رد الهيئة العامة للخدمات البيطرية: ما بين الاستقرار الحذر وخطة الطوارئ
على الجانب الرسمي، تقول الهيئة العامة للخدمات البيطرية إن الوضع الصحي الحيواني مستقر ومطمئن، وإن التحصينات الروتينية ضد الأنماط المتداولة مستمرة بوتيرة موسعة، مع تكثيف التقصي السريري في الأسواق والقرى والحيازات الصغيرة، الحديث داخل أروقة الطب البيطري يدور عن حزمة إجراءات احترازية تشمل تشديد الرقابة على منافذ الدخول، والالتزام الصارم بإجراءات الحجر الوقائي، والتوسع في الفحوصات المعملية السريعة، وتحديث خرائط المخاطر جغرافيًّا بحسب الموسم والحركة التجارية.
في ملف اللقاحات، يجري تقييم مطابقة التركيبات الحالية مع العترات الدارجة، مع تحضير خطوط إمداد تسمح بإدخال مستضدات جديدة إذا تطلب الأمر، المنطق بسيط لكنه بالغ الحساسية: كل يومٍ يمر بين رصد العترة الجديدة واعتماد لقاحٍ فعال هو يوم قد يتسع فيه نطاق العدوى، لذلك تتعامل الهيئة مع “الزمن” كعنصر أمان لا يقل أهمية عن الإبرة نفسها.
خطط المواجهة: كيف تتحول الدروس القديمة إلى استجابة أسرع؟
تتوزع خطة المواجهة على أربعة محاور تُكمل بعضها: الوقاية، والتحصين، والاستجابة السريعة، وتعويض المربين. في الوقاية، يشدد الأطباء على معايير الأمان الحيوي داخل المزارع: عزل الوافدات الجديدة لمدة كافية، تقييد الزيارات، تنظيم مسارات الدخول والخروج، وتطهير المعدات والأحواش، هذه قواعد تبدو بسيطة لكنها تفصل في الواقع بين موجةٍ تُخمد في أيام وأخرى تشتعل لأسابيع.
في التحصين، يجري العمل على سد أي فجوات في الجداول، وملاحقة الحيازات الصغيرة التي غالبًا ما تسقط من مظلة التغطية الكاملة، العبرة هنا ليست فقط بوفرة الجرعات، بل بإحكام الخريطة: أي بؤرة تفلت اليوم يمكن أن تصبح غدًا مركزًا لتفريخ عدوىٍ جديدة.
أما الاستجابة السريعة، فتتعلق بالقدرة على التقصي والعزل في الزمن الحقيقي، عندما يبلغ مربٍ عن أعراضٍ مشتبه بها، ينبغي أن يتحرك الفريق البيطري خلال ساعات، لا أيام، كل تأخير هو فرصة للفيروس كي يسبقنا بخطوة.
يبقى محور التعويض والدعم، وهو عقدة العقد بالنسبة لصغار المربين، الحديث يدور عن آلياتٍ أكثر مرونة لتخفيف كلفة التحصين والعلاج على الفئات الأكثر هشاشة، وعن صيغ تمويل قصيرة الأجل تسد فجوة السيولة في لحظة الأزمة، لأن قرار بيع القطيع بأكمله للخروج من النشاط هو أسوأ ما يمكن أن يحدث للاقتصاد الريفي ولسلسلة الإمداد معًا.
مشاهد من الميدان: كيف يروي المربون قصتهم بالأرقام والوجوه؟
في دلتا النيل، يصف مربٍ يمتلك قطيعًا من ثلاثين بقرة ألبان كيف تبدد شهر واحد من الحمى القلاعية أرباح ثلاثة أشهر كاملة، يتحدث عن انخفاضٍ مفاجئ في إنتاج اللبن بنحو الثلث في عز موسم التسويق، وعن قائمة أدوية تضاعفت أسعارها، وعن عجلين نافقا في أسبوعٍ واحد، يعلق بعبارة قصيرة لكنها موجعة: “كل ما بنقرب من التعادل، تيجي الموجة تاخدنا لورا”.
في صعيد مصر، يروي صاحب حظيرة تسمين أن دورة الشتاء الماضية تجاوزت الخمسة أشهر بأسبوعين إضافيين بسبب موجة مرضية مرّت على ثلاثة أرباع القطيع، يقول إن الوزن النهائي كان أقل من المستهدف بمتوسط عشرين كيلوغرامًا للرأس، وإن الفارق تحول إلى رقمٍ واضح في ورقة الحساب عند البيع، هذه الحكايات تتكرر بتنوعٍ في التفاصيل، لكنها تتطابق في الخلاصة: المرض لا يسرق فقط وزنًا أو لترًا، بل يسرق هامش النجاة الضئيل الذي يُبقي المشروع قائمًا.
أين يمكن أن تُحسم المعركة: على البوابة أم في الحظيرة؟
التجربة تقول إن نقطة الحسم الأولى تقع عند البوابة لا عند الحظيرة، تشديد إجراءات الحجر على الواردات، الالتزام بالنماذج المعملية والمدة الزمنية الكافية قبل السماح بالدخول، تتبع خطوط النقل من الميناء إلى المزرعة، وتوثيق الحركة بدقة؛ كلها حلقات إن ضعفت واحدةٌ منها دخل الفيروس من بين الأصابع، على مستوى الداخل، لا يقل صرامة الحركة بين المحافظات أهمية، خاصةً في مواسم الذروة التي تنشط فيها أسواق الماشية وتزدحم الطرق بالحيوانات المنقولة.
في الوقت نفسه، لا ينبغي أن تتحول الوقاية إلى عبء بيروقراطي يخنق النشاط الشرعي، هنا تبرز أهمية رقمنة الإجراءات وتقليل زمن الدورة الورقية، ما يرفع جودة الرقابة ويخفف كلفتها معًا الرقابة الذكية، وليست الرقابة الثقيلة، هي التي تحمي السوق والمربين في آن.
سؤال اللقاح: هل نستطيع السبق بدلًا من رد الفعل؟
الشكوى القديمة المتجددة هي أننا نصلح بعد وقوع الضرر، يقترح خبراء أن تنتقل منظومة اللقاحات من مربع “تحديث الاستجابة” إلى مربع “الاستعداد الاستباقي”، يعني ذلك بناء بنك مستضدات أوسع للعترات المرجح ظهورها في الإقليم، وتوقيع تعاقدات توريد مرنة، وتوطين خطوط إنتاج قادرة على إدخال مكون جديد سريعًا دون تعطيل الجداول القائمة، في حالة SAT1، يصبح السؤال المباشر: هل نستطيع اختبار وتدبير تركيبة فعالة، ووضع خطة توزيع جاهزة تُطلق فور التأكد من الحاجة، بدلًا من انتظار اتساع البؤر ثم الركض وراءها؟
ما الذي تقوله الأرقام عن الأثر الكلي على اللحوم والألبان؟
عند جمع الخسائر الجزئية عبر المحافظات، نصل إلى صورة كلية مقلقة، انخفاض الطاقة الحية المتاحة يعني طاقة ذبحٍ أقل في المجازر، ويعني كذلك إحجامًا من بعض المربين عن التسمين طويل الأجل، ما يضغط على المعروض في مواسم محددة ويُحدث قفزات غير مريحة للأسعار، في الألبان، التراجع المفاجئ في إنتاج الحظائر الصغيرة والمتوسطة يخلق موجات نقص لدى مصانع التجميع، فتُعاد صياغة الخلطات الصناعية أو تُرفع الأسعار لتعويض الفاقد، وفي الحالتين، المستهلك في نهاية السلسلة يدفع سعر المرض وهو لا يرى المراعي.
التقديرات المهنية التي يتداولها أهل القطاع تتحدث عن موجات سنوية يمكن أن تُفقد القطيع جزءًا معتبرًا من إنتاجيته الحولية، حتى مع انخفاض نسب النفوق المباشر في الأبقار والجاموس البالغين، الأثر المتكرر على العجول، وعلى خصوبة الإناث، وعلى معدلات التحويل، هو ما يصنع الخسارة الكبيرة بصمت.
رأس الماشية رمزٌ للأمن الغذائي لا مجرد حيوانٍ في الحظيرة
قد تبدو كلمة “مرض” تقنيةً تخص الأطباء، لكن الحمى القلاعية في واقع المصريين كلمة في ميزانية البيت، العترة SAT1 ليست مجرد كود مختبري جديد، بل احتمال لخسائر أخرى في قطاعٍ تعب كثيرًا خلال سنوات قليلة، إذا استطعنا أن نغلق الثغرات عند الحدود، وأن نُحصن على اتساع الخريطة، وأن نوفر دعمًا ذكيًّا للمربين في لحظة الأزمة، سنحافظ على ما تبقى ونستعيد بعض ما فُقد، أما إذا تكررت الأخطاء القديمة، فستتكرر النتائج: ثروة حيوانية أقل، وكلفة غذاء أعلى، وشعور عام بأننا نركض دائمًا وراء الفيروس بدلاً من أن نسبقه بخطوة.